
الحرارة تلهب الرؤوس .. الساعة تشير إلى منتصف النهار بتوقيت المغرب في يوم قائظ.. سائق الطاكسي مصرّ على مضاعفة الأجرة كعادة أقرانه حين يحسون بحاجة المسافر الملحة.. شباب في مقتبل العمر يرافقون قاصرين ما زالوا يجادلون في الثمن تدور أعينهم بين جنبات المحطة كلما لمحوا أحدهم انصرفوا إليه يتسولون درهما بداعي انقطاع السبل. بادرني أحدهم بالحديث قائلا: “هذا ليس عدلا”، شرحت له طويلا كيف أن عقليتنا ألفت استغلال حاجات الضعفاء، فصّلت له القول حتى أحسست بالرسالة وصلت وأحدثت مفعولها المنتظر، سألتهم من أين أنتم؟ متجنبا: “من أنتم؟” على غرار التعبير الديكتاتوري معمر القذافي لما مل شعبه منه وخرج يطالبه بالرحيل، أجاب أحدهم بشجاعة وافتخار: “أبناء تراست”، وهؤلاء الصغار معنا “أولاد الدرب” أصروا على مرافقتنا لمهرجان “تيفاوين”، كانوا يناهزون العشرة، وغالب الظن أنهم لا يملكون ما يكفي من مال لقضاء بغيتهم من سفرهم هذا، هواتفهم ترن فيبادرون بالإجابة يَرثون لغيرهم حالهم التي أصبحوا عليها بمحطة تيزنيت، تبادلوا أطراف الحديث قبل أن ينطلق هدير محرك السيارة معلنا القطيعة مع المدينة الهادئة. كان جل حديثهم حول السجون وأحوالها: فلان خرج أم ليس بعد؟ تحدثوا عنها كما نتحدث نحن عن منازلنا: صديقنا أخارج هو أم داخل؟ عجيب أمر هؤلاء. تحسست مواقع الهاتف في جيبي الأيمن حتى لا يصبح في عداد المفقودين هاته الأيام . تجنبت نظراتهم القاسية التي ترمق جوانب السيارة خلسة كمن يبحث عن شيء ثمين فُقد منه.
في الطريق ناموا ونحن مستيقظون، غريب أمر هؤلاء المساكين، أين ءاباءهم؟ أين المربون؟ أين أولياء الأمور؟ بل أين آثارهم على هؤلاء؟.. توقفت السيارة وسط “تافراوت”، نزلت واصحابي غير آبه بما حولي، سرعان ما سمعت أحدهم ينادي علي: “وابولفوقيا !” التفتت فإذا بصاحب السيارة يحمل إلي روايتي التي اقتنيتها حديثا بداعي الفضول، كانت تحمل عنوان “الآخرون” لحسونة المصباحي، شكرته ردا لجميله. أما واحد من زمرة “أبناء تراست” فسألني بأدب عجيب حول إمكانية الحصول على محل للكراء؟ أشرت عليه بالنفي, فانا مجرد غريب قاده حب الاستطلاع مثله قبل كل شيء لهذه البقعة الطاهرة التي أنجبت كبار الشخصيات الاقتصادية منها والفكرية.
تناولت وأصحابي وجبة غداء، كانت من بين الوجبات الأغلى في حياتي، قلت في قرارة نفسي بعدها: “إنه نذير شؤم بالنسبة لنا في هذه البلدة التي سبقها اسمها في الآفاق” رغم امتناع التشاؤم بالأشياء وأفضلية التفاؤل، شربت الماء كثيرا علّ ذلك يحفظ عروقي من الجفاف لشدة الحر لأن درجته هنا تناهز الأربعين، خرجنا من المقهى وعيوني مسمّرة على بابها باحثا عن ذلك الهلال الذي ألفته على أبواب الصيدليات الكبرى بارزا في النهار وفي الليل معا، إنها مقهى صيدلية بكل ما تحمله العبارة من معاني.
انصرفت أنا ورفاقي إلى إحدى المنازل للاستراحة رفقة دليل.. ركبنا الحافلة التي تنقل المسافرين صوب مدينة أكادير من الجهة الأخرى. كان الجابي بدوره انتهازيا خطيرا . طلب منا مضاعفة الأجرة من خمس دراهم إلى عشر، لكننا لم نلب طلبه هذه المرة، لقد سئمنا الانتهازيين ومعنا مرافقنا ودليل لنا يصعب نسيان خيره، لقد كان واحدا ممن لازم ركوب هذه الحافلة حوالي عشر كيلومترات جيئة وذهابا عن مركز تافراوت، جادله بالحجة والبرهان فتراجع عن قراره أخيرا.
في المساء، عدنا للمركز بعد استراحة قصيرة من وهج الحرارة، كان اللافت للانتباه أن تبدلت أحوال البلدة الهادئة.. أضواء ساطعة وشخوص قدمت من كل حدب وصوب يحدوها حب الاستطلاع. كان برنامج المهرجان في ظاهره متنوعا لكنه في الواقع لم يكن منصفا للكثيرين. لقد طغا عليه الصخب والسهر وضعف الفكر في ندوات صباحية كتب لها أن لا يحضرها إلا أهلها لسبب من الأسباب. آنذاك تذكرت الراكبين معي وتذكرت هدير المحرك في رحلة ليست كباقي الرحلات…
بقلم: احمد اضصالح






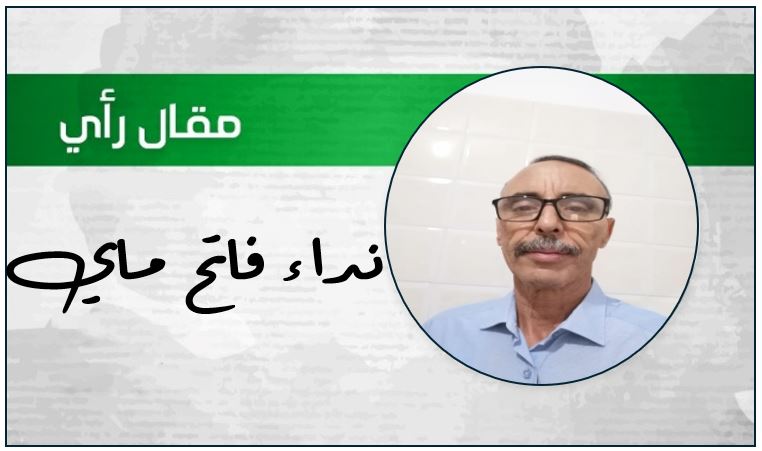
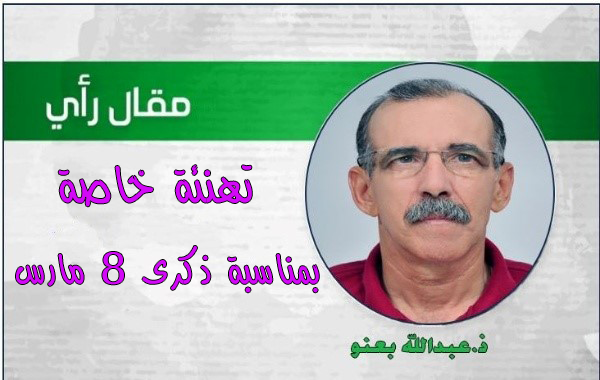


تعليقات