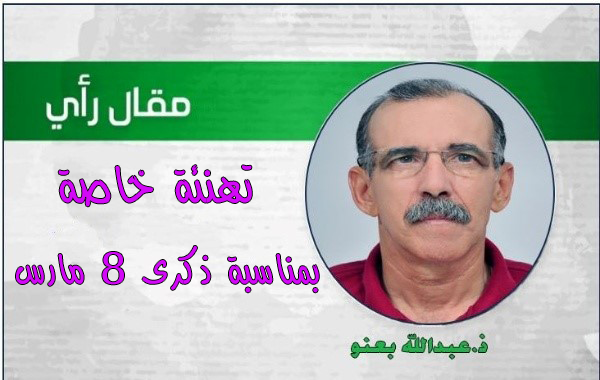يعتبر الإنسان الكائن الأكثر سعيا إلى تحقيق الأفضلية على غيره من المخلوقات ،فهو يسعى إلى تحقيق الريادة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها .إلا أن هذا المطمح غالبا ما يصطدم بالتدافع مع غيره من ذوي المطامح نفسها ، علما انه لكل ذي رغبة خلفية يدافع بها رغبته ومطمحه . حتى ولو تطلب الأمر استعمال العنف من اجل ذالك كما هو الأمر بالنسبة للحرب العالمية الأولي والثانية والحروب التي نشاهد اليوم علي جميع الشاشات، إنها حروب الدفاع عن الاديولوجيات وحماية المراتب الاجتماعية وان على الصعيد الدولي. ومن هذه المقدمة البسيطة ينبثق سؤال نرغب في البحث عن جوابه في هذه السطور البسيطة ؟ أليست المصالح هي التي تأجج معظم المشاكل اليوم، وما المحدد الحقيقي للمصالح ؟ المصلحة عقلية أم المصلحة الإيمانية؟
يعتبر الإنسان الكائن الأكثر سعيا إلى تحقيق الأفضلية على غيره من المخلوقات ،فهو يسعى إلى تحقيق الريادة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها .إلا أن هذا المطمح غالبا ما يصطدم بالتدافع مع غيره من ذوي المطامح نفسها ، علما انه لكل ذي رغبة خلفية يدافع بها رغبته ومطمحه . حتى ولو تطلب الأمر استعمال العنف من اجل ذالك كما هو الأمر بالنسبة للحرب العالمية الأولي والثانية والحروب التي نشاهد اليوم علي جميع الشاشات، إنها حروب الدفاع عن الاديولوجيات وحماية المراتب الاجتماعية وان على الصعيد الدولي. ومن هذه المقدمة البسيطة ينبثق سؤال نرغب في البحث عن جوابه في هذه السطور البسيطة ؟ أليست المصالح هي التي تأجج معظم المشاكل اليوم، وما المحدد الحقيقي للمصالح ؟ المصلحة عقلية أم المصلحة الإيمانية؟
إن موضوع المصلحة شائك ومعقد نظرا لصعوبة تحديد هذا المفهوم فقد سعي بعض الفلاسفة كبنتام في كتابه ” أصول الشرائع” إلي تحديد مفهومها وحدها .يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : ” ولقد حدا هذا بنتام أن يضع كتابه أصول الشرائع محاولا فيه تحديد النافع والملاذ بمقاييس مادية دقيقة مرتبا ما تفاوت منها محاولا إلزام القوانين بها .{ضوابط المصلحة ص29} بمعنى إن تحديد المنفعة أو ما نعبر عنه نحن بالمصلحة مرتبطة بكل ما من شانه إسعاد الكائن البشري بتحقيق لذة مادية يحس بها وينتعش بها. إذن فالمصلحة عند من يذهب هذا المذهب هو مقياس يتم بواسطته قياس الخير المحسوس والشر المحسوس .ومعرفة الفضائل من الرذائل. لكن هذا التعريف لم يسلم من مجموعة من الانتقادات أهمها : كون تحديد الملاذ والمنافع ترجع إلى مسألة داخلية للإنسان وهذا الأخير قد يدافع عن ما ليس له ولو بباطل أو كذب أو زور أو حسن الفصاحة أو غيرها فتضيع مصالح الآخرين بسبب هذا المعيار .
كما حاول فريق آخر من الباحثين تعريف المصلحة بإسناد تحديد المصالح إلي الأعراف والتقاليد. يقول غوستاف لوبون في كتابه “روح الاجتماع ” والذي يقود الناس إلي ولاسيما إذا اجتمعوا إنما هي التقاليد ” يريد بهذا الكلام كل ما هو مجمع عليه في مجتمع ما حتى اكتسب صبغة الرسمية وامتد مدة طويلة وأحس أفراده بإلزامية ذلك السلوك حتى أصبح ذلك مستندا لهم للدفاع عن المصالح. فكل عرف فيه مصلحة بدليل اعتراف الناس به.وهذا المذهب أيضا لم يسلم من توجيه بعض الانتقادات لاسيما انه ثمة تقاليد وعادات منافية تماما لمصالح الناس وهي ضد المصلحة العامة للإنسانية .منها ما كان من أعراف في الحضارة الرومانية قديما ، حيث استقبال المواليد الجدد في هذه الدنيا ساعة ولادته بوضعه في إناء ممتلئ بالنبيذ فان بقي حيا أبقوه عندهم للتربية والحياة، وان مات مات ميتة غير مأسوف عليها. ومن أمثلتها كذالك ما هو معروف عند العرب قبل الإسلام من وئد البنات خيفة العار والفضيحة وكذالك من الأعراف والتقاليد السيئة الذكر اليوم ما هو مشاهد من إتباع الشهوات والأهواء حيث يتم ضرب الأخلاق والعقل عرض الحائط . أما المصلحة في ما اصطلح عليها في الشريعة الإسلامية يمكن تحديدها بعد تعريفات ، فقد جاء التعريف الاصطلاحي لها لدى الأصوليّين مبنياً على المعنى اللغوي الدال علي النفع ونقيض الفساد ، وهو المحافظة على مقصود الشارع من الخلق في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم ونسلهم .فالمصلحة هي ” المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده ، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهم “.{ضوابط المصلحة ص23}. بخلاف المذاهب الفلسفية السابقة الذكر. و يذهب البوطي في تعريفه هذا للمصالح إلى كون المصلحة لا تكون محددة من طرف صاحب المصلحة نفسه ولا يحددها له مجتمعه بالاتفاق عليها كعرف أو تقليد وإنما وضعها في الشريعة الإسلامية وضع الهي باعتبار أن الله هو الخالق العالم الخبير بما من شانه تحقيق الصلاح والفلاح للبشر .قال تعالى :{ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}سورة الملك. إذن فكل ما هو موحى به في الوحيين القران السنة من أوامر ونواه مصالح للعباد ، أدرك الناس ذلك أم لم يدركوه. وهنا قد يأتي قائل ويقول إن القران الكريم حمال أوجه وما كثرة التفاسير علينا ببعيد .فنقول له إن حصول اليقين أن القران الكريم وحي رباني وهو عالم بما هو متضمن في كتابه ،والعلماء الربانيون موجدون في مختلف التخصصات العلمية ولاسيما اليوم الذي لا يتم الاعتماد فيه كثيرا على الأشخاص في الفتاوى بالدرجة الأولى وإنما على المؤسسات كالمجالس العلمية بصفة خاصة والمجامع الفقهية بصفة عامة .فيعرض كلام الله تعالى على هؤلاء في مسالة ما، فلابد من حوار تجمع عليه الأمة والإجماع من المصادر المتفق عليها في الشريعة الإسلامية. وكي لايفوتي اعتراض آخر – وهو اشد خطورة من الأول – مفاده أن النصوص الدينية والفقهاء اليوم في العالم الإسلامي أشبه ما يكون بما كان عليه القساوسة أيام غليليو .فهم يكبلون العقول بأغلال التحريم والتحليل وهم لايفهمون أي شئ سوى بعض متون النحو وأحكام الوضوء والصلاة .فكيف يشتغلون بالبحث عن حقائق مصالحنا ؟ طبعا هذا الاعتراض يبدو منطقيا ويبدوا مشروعا للناظر فيه للوهلة الأولى لكن الجواب عنه سهل للغاية هو أن الدورة الحضارية حكم عليها الله بكون من يتخذ أسباب التنافس الاقتصادي والصناعي يكون في الريادة الحضارية ، والشرع الإسلامي من خصائصه الواقعية. وليس في الأمر شئ آخر غير هذا كما يدعي العلمانيون إن أغلال الدين كبلت عقول المسلمين .صحيح أن التخلف نعيشه – نحن المسلمين – ومعنا القران الكريم لكن معنا أيضا من يعيش الأمر ذاته أو أقسى منه كما هو الأمر في بعض الدول الإفريقية. وللخروج من هذا الاعتراض أتذكر قولة تنسب للشيخ محمد عبده رحمه الله :يقول إن قضية الإسلام قضية عادلة لكن تولاها محام فاشل . فالمصالح عند فقهاء الشريعة ما يراه الله مصلحة فهو كذلك ،وما يراه الله مفسدة فهو مفسدة. وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الإيمانية { ما يراه الله مصلحة } لا يمكن أن تخرج عن نطاق المصلحة العقلية المستنبطة بعقل سليم متوازن.
هكذا إذا يتضح من خلال المقارنة أعلاه أن مرجعية المصالح تختلف باختلاف الناس واديولوجياتهم وأفكارهم .وهذا الاختلاف ما نراه المؤجج للصراعات المصلحية في العالم اليوم من خلال التدافع الحضاري ولا أريد أن اعبر عنه بالصدام – حتى لا نتهم بنهج العنف كخيار- فضل الصراع الغربي الشرقي إلى حدود 1991 بارزا في العالم حتى استسلام المعسكر الشرقي. وعاد الصراع مجددا ثنائها من جديد طرفاه العالم الإسلامي من جهة والغرب المسيحي غربا ولعنة اليهود كمحرك للطرفين .فالعالم الإسلامي لا يرضي أن يخضع إلا لأحكام الله ورسوله مبتغيا في ذلك كل المصالح والمنافع ، مدافعا عن شرائعه ولو بصدره العاري .والغرب المسيحي القوي عسكريا الفقير من حيث الموارد الطبيعية المتحدي لكل التحديات من اجل جلب المصالح ليضمن استمرار القيادة العالمية مدة أطول .
وفي الأخير نؤكد أن موضوع المصلحة موضوع صعب الإحاطة والتحديد .فهذه محاولة بسيطة من طالب علم بسيط ، يكتب هذه السطور ملخصا ما يعتقده في دينه الإسلامي الحنيف في هذا الموضوع، وان القلب أميل عندي إلى ترجيح كفة النظر العقلي الموافق لما في النظر النقلي . لان العقل البشري مهما بلع فهو شارد أو خائن أو ساه أو متوهم .والنقل ثابت لايتبدل ولا يتغير مهما قصر الزمان أو طال.
بقلم: عبد الله الغازي