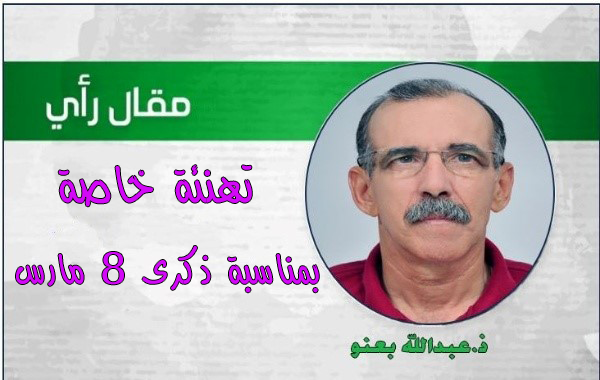وأنا متسمر قرب التلفاز في هذا الجو البارد، أتابع أحد القنوات الاخبارية العربية في نقاش موضوعه الاحداث الجارية في مصر حاليا، تدخل أحد رؤساء الاحزاب السلفية المصرية ، عبر التلفزيون وقال في ما قاله : اننا كحزب مستعدون للجهاد و لو بالسلاح للدفاع عن الشرعية المثمتلة في محمد مرسي ضد هؤلاء الباغون، (انتهى الخبر).
وأنا متسمر قرب التلفاز في هذا الجو البارد، أتابع أحد القنوات الاخبارية العربية في نقاش موضوعه الاحداث الجارية في مصر حاليا، تدخل أحد رؤساء الاحزاب السلفية المصرية ، عبر التلفزيون وقال في ما قاله : اننا كحزب مستعدون للجهاد و لو بالسلاح للدفاع عن الشرعية المثمتلة في محمد مرسي ضد هؤلاء الباغون، (انتهى الخبر).
حتى نختصر المسافات على بعض القراء فموقفنا من الحدث كله وجب ان يكون مبنيا على ان محمد مرسي منتخب عبر صناديق الاقتراع و ان الدفاع عنه او معارضته وجب ان تكون برنامج مع برنامج حجة ضد حجة لا ان تكون بالعنف و العنف المضاد . في الحقيقة الموضوع مثير للنقاش : هل ما قاله كلام في الهوى على الهواء ، او هو فتوى او ان الامر يدخل في صميم الضمير الجمعي الخاص بهذا النوع من الفكر ، ان كان فكرا اصلا ؟
سنحاول ملامسة هذا الموضوع من جوانب عدة علنا نصل الى نتيجة : ان هذا الكلام يكتسب خطورة لعدم انبنائه على اية اسس فكرية موضوعية تنهل مما خلفته الحضارة الانسانية ، و كذلك كونه بعيدا كل البعد عن ما تناوله مفكرو الاسلام في موضوعات السياسة خصوصا المعاصرين منهم كاجتهاد منهم لمسايرة التغيرات التي يعرفها العالم من شرقه الى غربه و من شماله الى جنوبه .
قال جون ستوارت ميل في كتابه (في الحرية): هناك مخاطر لانحراف الديمقراطية و تنويه بالاستقلال الذاتي و تعريض للتعصب في زمن كثرت فيه الدغمائيات من أهل اليمين و أهل اليسار .
اذاا كانت الحرية متصلة بالفعل، فانها لا ننفصل أيضا عن القول. فقط بالقول و الحكاية و السجال و المناظرة و التبادل و التداول يمكن للانسان. أن يبرز طابعه المدني و السياسي. فهو يتكلم لأنه ينخرط في العالم و يتواصل مع الغير. الكلام هو ظاهرة اجتماعية قبل أن يكون ظاهرة صوتية. و تعريف اللوغوس logos في الاغريفية يدل في الوقت نفسه على الكلام و التفكير من الفعل ( تكلم) legein . و من يتكلم فهو يفكر . أن يجمع بين النشاط العقلي و النشاط التواصلي بعرض الأفكار و استعراض المشاريع و الكشف عن النوايا أي أنه يمارس التفكير و يربطه بالعالم.
فالملاحظ أنه حتى التفكير المسيحي المتأثر بالرواقية .لم يكتف بترحيل سؤال الحرية من العالم إلى الذات، و من الشهادة إلى الغيب بل أقام بنقل الكلام من طابعه الإنساني الاجتماعي إلى بعده الميتافيزيقي. فليس الكلام مجرد وسيلة للتعبير بل هو أيضا هوية البشر فهو الذي يجعل الإنسان كائنا مدنيا يتواصل مع غيره و يريد الإفهام عن رغبة أو رهبة أو فكرة أو شعور أي أنه يمارس التفكير و يجسد الخواطر و النوايا في قوالب لغوية و مبادلات رمزية، لهذا السبب كل حظر للكلام هو قتل لجوهر الانسان و طبيعته البشرية، فليس غريبا اذن اذا كانت الأنظمة و الفكر التوتاليتاري لا تكتفي بتعزيز القوة و القمع و العنف، بل أيضا تقتل في الانسان هويته و هو التعبير. لهذا ينعدم الفضاء و الحوار العمومي في هذه الأنظمة المغلقة و لدى حاملي هذا الفكر و يسود الصمت و الاغراء و الإكراه.
اذا كان الكلام هوية الانسان فلأنه لا يشكل فقط التجسيد اللغوي للفكر او النشاط الفعلي للعقل ، و لكن ايضا لأنه على غرار الفعل ، شيء يبدأ باستمرار . الكلام هو بدئي ، يدشن لحظات جديدة من النظر و الممارسة ، انه مبتدأ الافعال و خبرها ، يتميز الكلام بالعفوية و السيولة لأنه الظاهرة الوحيدة التي لا يمكن الاحتفاظ بها سوى بالكتابة او التسجيل الصوتي . لكن عندما يتعلق الامر بالفضاء العمومي و السجالات السياسية و الاجتماعية ، فان الكلام يختفي على التو و لا يبقى منه سوى شذرات في الذاكرة ، لكن عفويته تثمن التجارب و تعزز الخبرات لأنه يتجلى في اشكال بلاغية او شعرية او برهانية لقرع الاذان المنصتة او اقناع الاذهان المشككة او المترددة ، فلا عجب ان يكون نطاق السياسة شبيها بالمسرح في العرض و الاداء ، اي بالذخائر الخطابية في التأثير على الجموع و قرع خيالها بتزيين المراد من القول و تحسين المراد من الفعل .
قال هيروقلطيس : ((لا يمكننا أن نستحم في النهر مرتين))، بمعنى ان صيرورة التاريخ لا ترحم فهو دائما متقدم الى الامام . لقد حاول الفكر الأوروبي الغربي أن يصوغ مفهوم للدولة. بالتأكيد على أن نظرية الدولة الاقليمية أو الوطنية أو دولة الحق كانت إجابة عن إشكالية إنسانية كبرى هي إشكالية التوفيق بين السلطة و الحرية في الاجتماع البشري، و كذلك تبدو نظرية الدولة الإسلامية التي نظر لها مفكرون معاصرون ينتمون الى الإسلام السياسي حيث نجد أن جلهم يتعلق بمدنية السلطة و الديمقراطية، لكن هذا التشابه بين النظريتين في مستوى الأهداف يبرز اختلافا بينهما في المقدمات و الانساق و النتائج . كيف ذلك ؟
بدأت الديمقراطية كما هو معروف من اليونان في أثينا منذ القرن الخامس قبل الميلاد ، لقد اعتبروا السياسة علما بتنظيم المجتمعات، و تركيز إرادتهم في بناء الدولة على المعرفة. و كان أفلاطون في فكرته عن عدالة الفرد كمدخل للعدالة في المدينة خير مثال على ذلك . و لاحقا اعتمد الاسلام السياسي على الفكرة الافلاطونية الأصلية عن الدولة أي ارتباطها بالأخلاق، و ضرب الجفاف الاخلاقي و القيمي للدولة الغربية، و نرى من ذلك كله أن مفهوم الدولة الإسلامية كما نظر له المفكرون الاسلاميون كأبو الاعلى المودودي و فهمي هويدي و راشد الغنوشي و يوسف القرضاوي و غيرهم، مأخوذ في نظرية الدولة في الثقافة الغربية لكن مع نوع من التحفظ موشوم بالخصوصية و التميز ، فحاولوا انجاز عملية مواءمة مؤسسة على نظرية الدولة الغربية لإنتاج نظرية السياسة الشرعية في الخلافة وفق منظومة عقائدية فلم يكتفوا بالتوفيق بين المستويين الفكري و الدستوري لمفهوم الدولتين بل ذهبوا الى أبعد من ذلك الى الغوص في أساساتها و مستنداتها الفلسفية، فوصلوا الى أن مفهوم الحاكمية معارض لمفهوم السيادة، و أن مفهوم الأمانة و الاستخلاف هو بديل مفهوم العقد ، و مفهوم الفطرة موازيا لمفهوم حالة الطبيعة. فاذا كان مفهوم العقد الاجتماعي عند روسو مفهموما لارادة الأمة أو الإرادة العامة معبرا عن أرادتها الأصلية في الحرية ، فان مفهوم إرادة الأمة لدى مفكري الإسلام السياسي معبرا عن إرادتها الفطرية المرتبط و المبنى على إرادة الله، و من تمة حين بنى منظرو فلسفة الدولة في الغرب إرادة الأمة بإرادتها الطبيعية الأصلية المرتبط بالقانون الطبيعي المستنتج من النظر في الطبيعة ككيان مادي مستقل بذاته، ذهب دعاة الإسلام السياسي أن تجسيدها في إرادة الله في القانون المستخرج من نظريتهم التوحيدية المفسرة لسلطة الله على كل ما في الوجود.
هذا في السياسة أما في صياغة الدساتير فان منظري الاسلام يعرفون دستورهم قياسا على دستور الدولة الغربية سواء في أركانه أو في مضامينه مع تحويله التحويلات الضرورية التي تقتضيها منظومتهم الفكرية ، فقد وجدوا في الشورى تواز للديمقراطية الانتخابية او التمثيلية و في الاجتهاد توافق مع الاجراء التشريعي و وجدوا في أعضاء السلطة من خليفة أو رئيس و أهل شورى أو أهل حل و عقد ما يعادل الرئيس و النواب في فلسفة الدولة الغربية. كل هذا من أجل تطلع الى تخليق الدولة و تأطيرها بمنظومة غائية دينية، لكن كل هذا يؤدي و يتسبب في تضييع الحرية. و هنا نطرح السؤال إذا كان تمثيل الأمة للإرادات الإلهية مشروطة بتطبيقها للشريعة، فهل تبقى الدولة المجسمة لهذه الإرادة دولة مدنية؟ من خلال هذا الاساس المتضمن في انتاجاتهم الفكرية ، هل يمكن ان نقول انهم تخطوا الامر من خلال تواجدهم في السلطة الى الايمان بضرورة مدنية الدولة و الاستفادة من حداثة الفكر العالمي كما نسمع الان في الخطب و ليس في الكتب ؟
هناك اذن تباين في المنطلقات و النتائج على الرغم من التناسق في المفاهيم لكن الجوهر يبقي شيء آخر. ان بناء الدولة المدنية وفق النمط الذي يرتضيه هؤلاء و اعتمادا على انتاجاتهم الفكرية يبقى بعيدا عن تحقيق مدنية الدولة رغم خطاباتهم الملمحة الى ذلك. ان مدنية الدولة و إرساء الديمقراطية الحقة داخل هذه المجتمعات الاسلامية لن يتأتى الا بالرجوع الى البذورالاولى للفكر الاسلامي و اعادة احياء الابحاث حول علم الكلام ( المتصوفة و المعتزلة على الخصوص ) و كذا الفلسفة الاسلامية التي انتهت تاريخيا و تجمدت بعد ابن خلدون و ابن رشد.
فالمعتزلة مثلا كان الكلام عندهم محكوم باعتبارات عقلية، جسدها حرصهم على الحقيقة باعتبارها هدفا أعلى و البحث عن تحقيق ارتباطات موضوعية بالعالم في حدود ما هو متاح لهم في زمانهم. ان افكار المعتزلة تمد جسورا حقيقية نحو دين مدني يؤصل حرية الانسان و يستزرعها بكل نتائجها السياسية دنيويا من خلال فكرتي العقل و الحرية التي تنطلق من ان لا ايمان بالإكراه، و لا احترام للتكليف الاجتماعي ما لم يحترم التكليف الديني الذي هو عقد حر عقلي بين العبد و ربه. العقل و الحرية اذن تجعل الانسان يملك السيادة على نفسه و هما عماد كل فعل يفعله الإنسان و هما أساس و جوده. لقد اوجبوا اذن أن الاحكام الشرعية مبنية على مبادئ عقلية أساسها مبدأ عمل التوحيد المعتزلي على عدم المساس بهما هما : تنزيه الله و حرية الانسان و قد حضر هذا التصور كذلك عند أفلاطون و الفارابي و روسو الذي يقول : أن الدين يتحول الى دين مدني انساني يصنعه الانسان عقليا دون أن يكف عن الايمان بالله بوصفه مرساة لحريته.
و كذلك المتصوفة فقد ذكروا باستمرار أن الايمان حالة وجدانية تربط الانسان بالله لا تخضع للوصف و القياس العقلي بل نقاس فرديا. الدين هو ممارسة أخلاقية ضميرية مما يكرس دور الارادة الانسانية الحرة في الايمان الخارجة عن كل قيد و كل قسر خارجي و المتمحورة حول علاقة المحبة و التواصل بين الخالق و مخلوقاته.
انه ما هو ملاحظ أنه لم تحصل في البلاد الاسلامية في ما بعد ابن خلدون و ابن رشد أي بادرة عقلية أو فكرية للتفكير بالمشاكل التي يطرحها الفكر الاسلامي ، أن ما كتب و ما ألق لدى المسلمين خصوصا في القرن 19 و 20 الى اليوم مقصور في توضيح أن الاسلام متفوق على ما عداه من الاديان ، دون اعمال عقل او تفكير في توضيح ذلك و هذا ما سيؤدي الى استغلاله من قبل حركات سياسية ايديولوجية، و يؤجل بذلك دافع البحث النقدي المتحرر و المحرر.
اذا كان عجز الفكر السياسي الاسلامي عن صياغة مفهوم للدولة و نظرية سياسية تحل أشكال التوفيق بين الحرية و والنفوذ نابعا لدرجة عميقة من مخاوفه المزمنة من مواجهة مفارقة التوحيد بجرأة ، فهل يجوز أن يبقى فكرنا العربي الاسلامي في محاولته التكيف مع متطلبات العالم المعاصر يرى في الفقه علما الأمان الذي يقيه مخاطر الاقتراب من المفاهيم الفلسفية و الكلامية ، فيقتصر على شرح العمل القويم و الصحيح عبر توفير حلول استعمال الفقه القديم لمشكلات جديدة و حديثة ؟
هذا من باب الكلام في الممارسة السياسية ، فماذا اذا اعتبرنا ذلك فتوى ؟ او هل هنالك من سيعتبر هذا التدخل على الهواء مباشرة فتوى ملزمة ؟ و لنا ان نتساءل : هل االفتوى قابلة للسحب أو الإلغاء ؟ الجواب هو لا بالتأكيد، ليس لأن الفتاوي في الاسلام دائمة أو قطعية أو غير قابلة لإعادة النظر بل لأن الفتاوى ليست فتوى أصلا و لا تنطبق عليها، بالتالي القواعد الشرعية الناظمة تقليديا لأصول اصدار الفتاوي و أحكامها. ان ممثلي الحقيقة المطلقة على الأرض الذين يصدرون هذه الفتاوى و الناطقين باسمها في هذه الدنيا لا يعترفون بالخطأ عادة حتى بعد أن يكون التاريخ قد تجاوزهم تماما و حتى بعد أن تكون حقائق العالم قد أتبتث خطأهم بالكامل على سبيل المثال لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية رسميا بأنها أساءت الى غاليليو و بأنها ارتكبت خطأ جسيما بإدانته و اضطهاده و تكفير علمه الجديد و منع تداول مؤلفاته أو دراستها أو قراءتها الا بتاريخ 30/10/1992 أي بعد 359 عاما من تاريخ التجريم الأصلي. و هذا منطبق كذلك على فيلسوف عظيم في اوربا هو سبينوزا الذي حكموا عليه كبار حاخامات اليهود في امستردام سنة 1656 بالكفر و بالارتداد و بالطرد من الكنيس اليهودي و من الجماعة المؤمنة بسبب أبحاثه الفلسفسة الثورية الجديدة و قناعاته العلمية الديكارتية المخالفة في مضامينها الموروث الديني الشرعي. و حتى يومنا هذا لم يستطع كبار الفلاسفة و المفكرين و العلماء يهود و غير يهود. من اقناع المراجع الدينية اليهودية بالغاء الحكم الصادر بحق هذا الفيلسوف الكبير أو سحبه .
الامر اذن اعقد مما نتصور ، اختلط الحابل بالنابل و تعددت التدخلات الفاقدة للمعنى و المنهج والغير المرتبطة بالتأصيل الصحيح للمقاصد و وجدنا انفسنا امام سيل جارف من الاجتهادات التي لن تؤدي الا الى مزيد من التأزيم و التقهقر . ان هذا النوع من الفكر ( السلفي ) ، هو بعيد حتى عن ما خلفه منظرو الاسلام السياسي المعتدل الذين ذكرنا بعضهم سابقا . لأنهم ببساطة لا ينظرون الى الامور الا من زاوية اسود او ابيض لا غير .
العقلانية و الديموقراطية هما الحل .
بقلم : علي بن الطالب